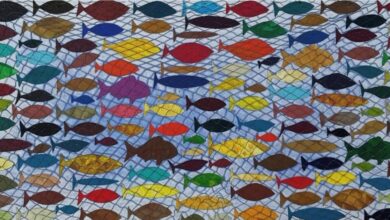الدروع أم الخلود؟ 6 مبدعين غيّروا وجه الفن العربي بلا جوائز ولا ترند

في قلب القاهرة القديمة، وتحديدًا في حي الخليفة حيث يمتد سوق الإمام الشافعي، يختلط غبار التاريخ بزحام المهمّشين في ما يُعرف بـ”سوق الجمعة”. هناك، وقعت حادثة تختصر عبثية الألقاب: بائع أغراض قديمة يفترش الأرض عارضًا مقتنيات الفنان المصري القدير نور الشريف.
كانت دروع التكريم النحاسية وشهادات التقدير المذهّبة التي تسلّمها في أرقى المحافل الدولية والمحلية ملقاة تحت أشعة الشمس، يُساوم عليها المارّة كقطعٍ من معدنٍ قديمٍ فانٍ.
لم يكن هذا المشهد مجرد ضياع لتركة فنان، بل إعلانًا صريحًا عن هشاشة الجائزة كقيمة مادية تُذرّيها الرياح بمجرد غياب صاحبها. فالدرع الذي يلمع تحت الأضواء قد ينتهي في سوق الخردة، ما لم يسنده أثرٌ يتجاوز حدود المادة.
الجائزة، في جوهرها، فعلٌ إداريّ ينتهي بموت صاحبها؛ أمّا الأثر فهو فعلٌ وجوديّ لا يملك أحدٌ صياغته أو بيعه أو شراءه.
فلسفة الأثر في وعي الأجيال
بعيدًا عن الأنماط التقليدية في نقد الفن، يميل الوعي المعاصر إلى تقديس الحقيقة الفنية أكثر من التكريمات الرسمية التي قد تخضع أحيانًا لحسابات السياسة أو المصالح الضيقة. ويمكن تأطير هذا التحوّل عبر آراء باحثين فككوا العلاقة بين المبدع والمؤسسة.
يرى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو أن المؤسسات تمنح الجوائز لتُمارس “سلطة التسمية“: أن تحدد للمجتمع ما هو الفن المقبول وما هو المرفوض وفق معاييرها الخاصة. لكن ثمة فنانون اخترقوا هذا المنطق؛ لم ينتظروا اعترافًا من وزارة أو لجنة، بل بنوا شرعيتهم من رأسمال رمزي استمدوه من وجدان الشارع.
أما الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، ففرّق بين “المبدع التقليدي” و”المبدع العضوي” الذي يلتحم بقضايا شعبه، معتبرًا أن الأثر الحقيقي يكمن في قدرة الفن على تغيير وعي الناس، وتحويل العمل الفني إلى نمط حياة يوميّ يتنفّسه الجمهور من دون حاجة إلى تسويق أو إعلانات ممولة.
لنتأمل، مثلًا، حضور ألحان كُتبت قبل عقود: كيف لأغنية مثل “ألف ليلة وليلة” التي صاغها بليغ حمدي قبل أكثر من نصف قرن، أو “الديك بينده” لسيد درويش التي تجاوز عمرها مئة عام، أن تظل حاضرة في أرقى المسارح والمنصات الرقمية الحديثة؟
إن هذا الوجود المستمر- أن يهتز شابٌ في العشرين على لحنٍ صيغ قبل ولادته بعقود – هو التكريم الحقيقي الذي يسخر من كل الدروع الملقاة في سوق الإمام.
هؤلاء لم يصنعوا فنًا لتصدّر قوائم المشاهدات المؤقتة، بل صاغوا “شفرةً جينية” موسيقية صالحة للعمل في كل عصر، متحدّين فكرة الفناء التي تلاحق الجوائز المادية والنجومية الزائفة.
نماذج من الخلود
ليس المقصود هنا إعداد “قائمة شرف” جديدة تحلّ محل الجوائز، ولا تحويل الأثر إلى بطولة فردية معزولة عن سياقاتها.
المقصود هو التقاط خيطٍ واحد يجمع بين تجارب متباعدة في الجغرافيا واللغة والأسلوب: أن الفن حين يلتصق بالناس، بحياتهم اليومية، وبآلامهم الصغيرة، وبأحلامهم الكبرى، يصبح أقوى من المؤسسة، وأطول عمرًا من التكريم.
هؤلاء المبدعون لم يتشابهوا لأنهم رفضوا الجوائز فحسب، بل لأنهم صنعوا أعمالًا قادرة على العيش خارج زمنها، والعودة إلينا كل مرة بوصفها لغةً حاضرة لا أرشيفًا قديمًا.
بعضهم رحل مبكرًا، وبعضهم اعتزل أو انسحب، وبعضهم ظل يصطدم بالسلطات والذائقة الرسمية… لكن القاسم المشترك بينهم أنهم تركوا “أثرًا” لا يحتاج إلى ختمٍ ولا إلى منصة: يكفي أن يُعاد عزفه، أو يُستعاد في جملة، أو يهمسه الناس في الطريق، حتى نعرف أنه ما زال حيًا.
سيد درويش: فنان الشعب والمجدّد الأول
سيد درويش مجدد الموسيقى العربية الذي لم يعايش الجوائز والتكريم- الأهرام
يُعدّ سيد درويش معجزةً لم يمهلها الموت طويلًا، لكنها غيّرت مسار الموسيقى العربية إلى الأبد.
قبل درويش، كانت الموسيقى غارقة في قوالب عثمانية وتطريبٍ يخدم مجالس ضيقة ونخبًا حاكمة.
جاء سيد درويش لينزل بالموسيقى إلى رصيف الشارع: لحّن لعمّال البناء، وللسقاة، وللحمالين، وجعل لكل فئة نشيدًا يعبّر عن كرامتها وإنسانيتها.
يتجلّى أثره في أنه أدخل التعبير الدرامي والمسرحي إلى اللحن، محوّلًا الأغنية من حالة سكونية هدفها الإطراب المجرد إلى حالة حركية نابضة تعبّر عن الموقف والحدث. وكان يردد:
“إنني لا أغني للقصور، بل أغني للناس الذين يصنعون الحياة بجهدهم وعرقهم”.
رحل درويش في الحادية والثلاثين فقيرًا، وطورد بسبب أثره الشعبي، ولم ينل في حياته وسامًا رسميًا. لكنه ترك “بلادي بلادي” التي صارت نشيدًا وطنيًا، وألحانًا مثل “زوروني كل سنة مرة” لا تزال تُغنى في كل بيت عربي كأنها وليدة اللحظة، متجاوزة قرنًا كاملًا من الزمن.
بليغ حمدي: عبقري النغم وملك الوجدان
بليغ حمدي الذي تعيش ألحانه حتى في جيل اليوم – الأهرام
لم يكن بليغ حمدي مجرد ملحن، بل إعصارًا موسيقيًا اجتاح النصف الثاني من القرن العشرين، وغيّر ملامح الأغنية العربية بعبقرية خام.
تكمن عظمته في قدرته على تبسيط المعقّد: استلهم الجملة الشعبية المصرية وصاغها بأسلوب عصري عالمي، مُدخلًا الغيتار والساكسفون إلى عمق التخت الشرقي من دون أن يشوّه هويته الأصيلة.
صنع بليغ أمجاد كبار النجوم؛ أعاد الحيوية لصوت أم كلثوم، وجعل عبد الحليم حافظ يغني بلسان جيل السبعينيات.
ورغم هذا العطاء، قضى سنواته الأخيرة متنقّلًا بين باريس ولندن وحيدًا، مثقلًا بأزمة قانونية وبشعورٍ بالظلم والتجاهل الرسمي. وكان يقول في منفاه إن الموسيقى وطنه الحقيقي، وإن الناس “لجنتُه” الوحيدة التي يحترم تقييمها.
مات بليغ وفي نفسه غصّة، لكن ألحانه تعيش اليوم عصرها الذهبي، مؤكدةً أن عبقريته كانت تسبق زمن لجان التكريم بمسافات شاسعة، وأن صوته الموسيقي هو “الترند” الذي لا يموت.
الشيخ الحسناوي: أسطورة الحنين وصوت الهجرة
الشيخ الحسناوي- فيسبوك
يمثّل الشيخ الحسناوي، ابن منطقة القبائل في الجزائر، حالة فريدة من الزهد الفني والخلود المعنوي.
غنّى للغربة قبل أن تتحوّل إلى ظاهرة اجتماعية، فصار صوته أنيسًا للمهاجرين الأمازيغ والعرب في فرنسا وفي أرجاء المغرب العربي.
لم يسعَ الحسناوي إلى منصب أو وسام؛ ركّز على عالمية الوجع الإنساني وتوثيق مأساة الابتعاد عن الجذور.
في قمة شهرته عام 1968، قرر الاعتزال والرحيل نحو صمتٍ مطبق، رافضًا محاولات إعادته للمسرح أو تكريمه رسميًا.
كان جوابه على عروض التكريم هو الغياب، كأنه يقول إن الفن الذي يخرج من معاناة الناس لا يحتاج صكوك اعتراف من المؤسسات.
مات في جزيرة نائية بعيدًا عن صخب الإعلام، لكن صوته ظل يتردد في الجبال والمدن، وصار اسمه رمزًا للنقاء الفني والتمسك بالأصالة بعيدًا عن ضجيج الجوائز.
زياد الرحباني: المتمرد الساخر وهادم الأوهام
رفض زياد الرحباني منطق الجوائز وغاص في الشارع أكثر مفضلًا الأثر الموسيقي المباشر على المجتمع- النهار
في بيروت، وبخلاف المسار الرحباني الذي رسم صورة مثالية للضيعة، جاء زياد ليصدم الوعي العربي بالواقع العاري بسخرية مرة.
أثره يتجاوز التلحين إلى صناعة ثقافة نقدية كاملة؛ أدخل الجاز إلى الروح الشرقية بذكاء، وصنع مسرحيات مثل “بالنسبة لبكرة شو” و”نزل السرور” التي لا يزال الجمهور يحفظ حواراتها غيبًا.
جعل الضحك الأسود سلاحًا لمواجهة الحرب والفقر والزيف السياسي والاجتماعي.
اشتهر بموقفه الرافض للرسميات، وكان يقول بسخريته المعهودة إن الجوائز “شهادات وفاة مبكرة” للفنان، وهو يختار أن يبقى في الشارع مع الناس.
هذا الزهد الواعي في التكريم هو الذي منح فنه تلك المصداقية الهائلة؛ فألحانه تعيش اليوم في المقاهي الشعبية وفي حافلات النقل العام، ليس كذكرى عابرة بل كحالة راهنة تعبر عن تطلعات الإنسان العربي المعاصر، من دون أن يحتاج لوسام رسمي ليثبت عبقريته.
الثنائي أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام: جامعة الرفض الشعبي
الثنائي المتمرد نجم وإمام – الأهرام
لا يكتمل الحديث عن أثرٍ عابر للأجيال بلا جوائز من دون التوقف عند تجربة أحمد فؤاد نجم والشيخ إمام.
من حارة حوش قدم بالقاهرة، صنع الثنائي إعلامًا شعبيًا بديلًا في زمن الصمت.
كلمات نجم الحادة والساخرة، وصوت إمام الضرير وعوده، شكّلا جبهة مقاومة ثقافية اخترقت جدران السجون والحدود.
لم يحصل أي منهما على جائزة دولة في حياته؛ كانت “جوائزهما” الزنازين والتضييق والمنع من الظهور الرسمي. وكان نجم يقول بجرأته: “جائزتي الحقيقية حين أسمع عاملًا أو طالبًا يغني كلماتي صباحًا؛ أما دروعكم فاحتفظوا بها لمكاتبكم الباردة”.
ماتا فقيرين من حيث المتاع المادي، لكنهما تركا ثروة لا تنضب من الوعي والتمرد، وأثرًا يتجدد مع كل نداء للعدالة والحرية في أي بقعة من الوطن العربي، لتظل أغانيهما هي القوة المحركة للوجدان الجماعي الذي لا تسيطر عليه مقصات الرقابة.
صبري المدلل: حارس القلعة الحلبية وزاهد الطرب
شيخ الطرب صبري المدلل- تلفزيون سوريا
يمثل صبري المدلل قمة الإخلاص للتراث الموسيقي الرفيع في بلاد الشام.
حافظ على نقاء القدود الحلبية والموشحات الأندلسية في زمن غلبت فيه الروح التجارية.
لم يكن المدلل يغني طلبًا للشهرة، بل لوجه الفن الخالص.
جمع بمهارة بين التقوى الصوفية والبراعة الطربية، ولم تغره الجوائز التي عُرضت عليه في جولاته الخارجية بقدر ما أغراه الحفاظ على الهوية السمعية لحلب وتوريثها للأجيال.
كان يقول إن الفن “عبادة”، والعبادة لا تطلب درعًا نحاسيًا بل محبة الناس.
رحل المدلل تاركاً مدرسة فنية هي المرجع الأساسي لكل من يبحث عن الأصالة، ويتجلى أثره اليوم في كل محفل طربي يرفض التنازل عن شروط الرقي والصفاء الموسيقي، بعيدًا عن ضوء الترندات الزائلة.
الجوائز الزائلة والأثر المتبقي
تقودنا سِيَر هؤلاء المبدعين الستة إلى خلاصةٍ لا تقبل الشك: الجائزة قد تصنع نجمًا لموسمٍ واحد، أما الأثر فيصنع خالدًا يتجاوز الزمان والمكان. وبينما تصدأ الدروع في غبار سوق الإمام وتُباع كخردة، تظل ألحانهم وكلماتهم تجري في عروق الثقافة العربية كدمٍ متجدّد.
لقد أثبت سيد درويش وبليغ حمدي والشيخ الحسناوي وزياد الرحباني ونجم وإمام وصبري المدلل أن الاعتراف الشعبي والخلود الفني هما الجائزتان الوحيدتان اللتان تمنحان الفنان حق البقاء في ذاكرة الحياة، بلا تكريم رسمي ولا ترند زائل.
المراجع
-
تقارير صحافية؛
-
كتاب “سيد درويش إمام الحداثة الموسيقية” للباحث فيكتور سحاب؛
-
مذكرات بديع خيري؛
-
كتاب “بليغ حمدي سلطان الألحان” للكاتب أيمن الحكيم؛
-
دراسات في الأنثروبولوجيا الثقافية حول أغنية الهجرة الجزائرية؛
-
أبحاث جامعة مولود معمري في تيزي وزو؛
-
كتاب “زياد الرحباني المسرح والموسيقى” للناقد عبيدو باشا؛
-
السيرة الذاتية لأحمد فؤاد نجم “الفاجومي”؛
-
كتاب “الشيخ إمام سفير الفقراء” للباحث سيد محمود؛
-
كتاب “تاريخ الموسيقى السورية” للناقد صميم الشريف؛
-
كتاب “التمييز” لبيير بورديو؛
-
“كراسات السجن” لأنطونيو غرامشي حول مفهوم المثقف العضوي.